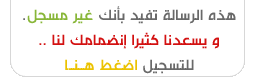
| واحة النحو والصرف هنا توضع الموضوعات المتعلقة بقواعد علمي النحو والصرف |
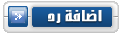 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
الأخ "أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن" تم القبض عليه بعد أحداث إمبابة الماضية ، وكان قال كلامًا يتوعد فيه بحرق الكنائس بعد الأحداث ، وكان هذا بعد أن طاش عقله بعد إطلاق النار عليه وعلى إخوانه ، والقنابل ، ورؤيته الدماء والإصابات والقتلى ، فهو في عدم وعيه ، وليس مؤاخذًا بمثل هذا الكلام في هذه الحال ، وهو قدم اعتذارًا عن قوله وهو لا يتذكر شيئا مما قال وكاد ينفيه ، رغم أنه من طلب تسجيله وإذاعته . |
|
#2
|
|||
|
|||
|
لا حول ولا قوة إلا بالله .
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
أسئلة على نيابة الواو عن الضمة س82: لماذا أتى المؤلِّف - رحمه الله - بعلامة الواو بعد علامة الضمَّة؟ الجواب: أتى المؤلف - رحمه الله - بالواو بعد الضمَّة، ولم يأتِ بالألف، ولا النون بعدها؛ لأنَّ الضمَّة إذا أُشبعت تولَّد منها الواو، فالواو أقربُ شيء للضمَّة؛ فلهذا جعَلَها المؤلف تُواليها. س83: في كم موضع تكون الواوُ علامةً للرفع؟ وما هو الدليل على ذلك؟ وما هُما هذان الموضِعان؟ الجواب: تكون الواو علامةً للرفع في موضعين، والدليل على ذلك هو التتبُّع والاستقراء، فإنَّ علماء اللُّغة - رحمهم الله - تَتبَّعوا كلامَ العرب، فوجدوا أنَّ الذي يُرفع بالواو لا يَعْدو شيئين. وهذان الموضعان هما: جمْع المذكَّر السالِم، والأسماء الخمسة.  س84: ما هو جمع المذكر السالم؟ مَثِّل لجمْع المذكر السالِم في حال الرفع بثلاثة أمثلة. الجواب: جمع المذكر السالِم هو: اسمٌ دالٌّ على أكثرَ من اثنين، بزيادة واو ونون في حال الرفْع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، صالح للتجريد عن هذه الزِّيادة، وعَطْف مثله عليه. وأمَّا الأمثلة على جمْع المذكَّر السالِم في حال الرَّفْع، فهي: المثال الأول: قال - تعالى -: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ [التوبة: 81]. المثال الثاني: المثال الثالث: قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: 8]. فكلٌّ من "المخلفون"، و"الراسخون"، "المؤمنون"، "المجرمون" جمع مذكَّر سالِم، دال على أكثرَ من اثنين، بسببِ الزيادة في آخرِه - وهي الواو والنون - وهو صالِح للتجريد مِن هذه الزيادة، ألاَ ترى أنَّك تقول: مُخلَّف، وراسِخ، ومؤمن، ومجرم. وكلُّ لفظ مِن ألفاظ الجموع الواقِعة في هذه الآيات مرفوع، وعلامة رفْعه الواو نيابة عن الضمَّة، وهذه النون التي بعدَ الواو عوض عن التنوين في قولك: "مُخَلَّفٌ" وأخواته، وهو الاسم المفرد.  س85: اذكرِ الأسماء الخمسة، واذكر ما الذي يُشترط في رفعها بالواو نيابةً عن الضمَّة؟ ولو كانتِ الأسماء الخمسة مجموعةً جمْع تكسير فبماذا تُعرِبها؟ ولو كانت الأسماء الخمسة مثنَّاة فبماذا تُعربها؟ ومَثِّل بمثالين لاسمين من الأسماء الخمسة مثنيين، وبمثالين آخرين لاسمَينِ منها مجموعين. ولو كانتِ الأسماء الخمسة مصغَّرة فبماذا تُعرِبها؟ ولو كانت مضافةً إلى ياءِ المتكلِّم فبماذا تُعرِبها؟ وما الذي يشترط في "ذو" خاصَّة؟ وما الذي يشترط في "فوك" خاصَّة؟ الجواب: الأسماء الخمسة هي: أبوكَ، وأخوكَ، وحموكِ، وفوكَ، وذو مالٍ. ويُشترط في رفعها بالواو نيابةً عن الضمَّة: أن تكون مُفردة، مُكَّبرة، مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرِ ياء المتكلِّم. ومثال ما تمَّت فيه الشروط: قوله - تعالى -: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يوسف: 94]، وإعراب هذه الآية هكذا: قال: فعل ماضٍ مبنيٌّ على الفتح. أبوهم: أبو: فاعل - لأنَّه هو الذي صدَر منه القول - مرفوع، وعلامة رفْعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، و"أبو" مضاف، و"هم" مضافٌ إليه. ولو كانتِ الأسماء الخمسة مجموعةً جمْع تكسير، فإنَّها تُرفع بالضمَّة، لا بالواو، كما سبق أنْ ذكَرْنا أنَّ جمع التكسير يُرفع بالضمة. ولو كانتْ مُثنَّاة: أُعربت إعرابَ المثنى، بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًَّا. ومثال الأسماء الخمسة المثنَّاة أن تقول: أبواك ربَّيَاك، وأخواك علَّماك. فكل من "أبواك، وأخواك" مثنيان، وهما مرفوعانِ بالألف، لا بالواو؛ لأنَّهما مثنَّيان. ومثال الأسماء الخمسة المجموعة جمْعَ تكسير: قوله - تعالى -: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ﴾ [النساء: 11]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]، فكلٌّ من (آبَاؤُكُمْ، وإخوة) جمعَا تكسير، وهما مرفوعانِ بالضمَّة، لا بالواو، لأنهما جمعَا تكسير. ولو كانتِ الأسماء الخمسة مصغَّرة، فإنها تُرفع بالضمة، تقول: هذا أُبَيٌّ وأُخَيٌّ. فكل من "أُبَيّ، وأُخَيّ" مرفوعانِ، وعلامة رفعهما الضمَّة الظاهرة، على الرغم مِن كونهما من الأسماء الخمْسة؛ وذلك لأنهما مُصغَّران. ولو كانتْ مضافةً إلى ياء المتكلم: فإنها تُرْفَع بضمَّة مُقدَّرة على ما قبل ياء المتكلم، منَع من ظهورها اشتغال المحل بحرَكة المناسبة؛ لأنَّ ياء المتكلِّم يناسبها الكسرة. ومثال إضافة الأسماء الخمسة لياءِ المتكلِّم تقول: حضر أبي وأخي. فـ"أبي" فاعل بـ"حضر" مرفوع، وعلامة رفْعِه ضمَّة مُقدَّرة على ما قبل ياء المتكلِّم، منَع من ظهورها اشتغالُ المحل بحركة المناسبة. و "أخي" معطوف على "أبي" المرفوع، مرفوع، وعلامة رفْعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منَع من ظهورها اشتغالُ المحل بحرَكة المناسبة. ويُشترط في "ذو" خاصَّة شرطان: 1- أن تكون بمعنى "صاحب"، احترازًا مِن "ذو" التي بمعنى "الذي" كما هي لغة طيِّئ. 2- أن يكون الذي تُضاف إليه اسمَ جنس ظاهرًا، غير صفة، نحو: جاءني ذو مال، ولا يجوز: جاءني ذو قائم. ويشترط في "فوك" خاصَّة أن تكون خاليةً من الميم.  س86: قال الله تعالى: ﴿ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ [الأعراف: 71]. "آباؤكم" ما هي علامة رفْعها؟ الجواب: علامة رفْعها الضمَّة؛ وذلك لأنَّها جمع تكسير، وجمْع التكسير يُرفع بالضمة، ولم تُرفعِ بالواو على الرغم مِن كونها من الأسماء الخمسة؛ لأنَّ مِن شرط رفع الأسماء الخمسة بالواو أن تكون مُفرَدة، وهذه جمْع، كما سبق. س87: قال شاعر طيِّئ سنان بن الفحل: فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي  وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ  ما تقول في "ذو" هنا، هل هي مِن الأسماء الخمسة؟ الجواب: لا؛ لأنَّها ليست بمعنى "صاحب" ولكنَّها بمعنى "الذي"؛ ولهذا لا تُعرَب إعراب الأسماء الخمسة، وتكون مبنيَّة على السكون دائمًا؛ أي: في حالة الرفْع النصْب والجر.  س88: قال - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: 105]. ما تقول في "ذو" هنا، هل هي مِن الأسماء الخمسة؟ الجواب: نعم؛ وذلك لأنَّها استوفتِ الشروط كلها، فهي مفردة مكبَّرة، مضافة، إلى غير ياء المتكلِّم، وهي بمعنى "صاحب"، وهي مضافة إلى اسمِ جِنس ظاهر، غير صفة؛ ولذلك فهي مرفوعةٌ بالواو نيابةً عن الضمَّة. وإعراب هذه الآية يكون هكذا: اللهُ: لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامة رفْعه الضمَّة الظاهرة. ذو: خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفْعه الواو نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف. والفضلِ: مضاف إليه مجرور، وعلامة جرِّه الكسرة الظاهرة. العظيمِ: صفة لـ"الفضل" مجرورة؛ لأنَّ صفة المجرور مجرورة، وعلامة جرِّها الكسْرةُ الظاهِرة.  س89: تقول: هذا فمُك، برفْع "فم" بالضمَّة، فلماذا لم تُرفعْ بالواو؟ الجواب: لأنَّ مِن شروط رفْع "فو" بالواو أن تكون خاليةً من الميم، وهنا بها ميم؛ ولذلك تُرفَع بالضمَّة؛ لأنها اسمٌ مفرد.  س90: أعرب ما يلي: • قَعَد أبوك وراءك. • جاء أبوان. الجواب: قعَد: فعل ماضٍ، مبني على الفتْح، لا محلَّ له من الإعراب. أبوك: أبو: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعه الواو نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه من الأسماء الخمْسة، وأبو مضاف، والكاف ضميرٌ مبنيٌّ على الفتْح، في محلِّ جر مضاف إليه. وراءك: وراء: ظرْف مكان منصوب، وعلامة نصْبه الفتحة الظاهرة، ووراء مُضاف، والكاف ضمير مبنيٌّ على الفتْح، في محلِّ جر، مضاف إليه. المثال الثاني: جاء أبوان. جاء: فعلٌ ماضٍ مبني على الفتْح، لا محلَّ له من الإعراب. أبوان: فاعلٌ مرفوع، وعلامة رفْعه الألف نيابةً عن الضمة؛ لأنَّه مثنًّى. وهي هنا لا تُرفع بالواو، وعلى الرغم مِن كونها من الأسماء الخمسة؛ وذلك لأنَّها فَقَدَتْ شرْطَ الإفراد، فهي مثنًّى.  س91: بيِّن المرفوع بالضَّمَّة الظاهرة، أو المقدَّرة، والمرفوع بالواو مع بيان نوْع كل واحد منها، مِن بين الكلمات الواردة في الجُمل الآتية: • قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: 1 - 5]. • قال الله تعالى: ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: 53]. • الفِتْنة تُلْقِحُها النَّجْوى، وتنتجها الشكوى. • إخوانك هم أعوانُك إذا اشتدَّ بك الكرب، وأُسَاتُك[1] إذا عضَّك الزمان[2]. • النائِبات محكُّ الأصدقاء. • أبوك يتمنَّى لك الخير، ويَرْجو لك الفَلاح. • أخوك الذي إذا تَشكو إليه يشكيك[3]، وإذا تدعوه عندَ الكرب يُجيبك. الجواب: الكلمة المرفوعة بالضمة الظاهرة الكلمة المرفوعة بالضمة المقدرة الكلمة المرفوعة بالواو نوع الكلمة المؤمنون جمْع مذكَّر سالِم خاشعون جمْع مذكَّر سالِم معرضون جمْع مذكَّر سالِم فاعلون جمْع مذكَّر سالِم حافظون جمْع مذكَّر سالِم المجرمون جمْع مذكَّر سالِم مواقعوها جمْع مذكَّر سالِم الكلمة المرفوعة بالضمة الظاهرة الكلمة المرفوعة بالضمة المقدرة الكلمة المرفوعة بالواو نوع الكلمة الفِتنة اسم مفرد تلقحها فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ النَّجْوى اسم مفرد تنتجها فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ الشكوى اسم مفرَد إخوانك جمْع تكسير أعوانك جمْع تكسير الكرب اسم مفرد أساتك جمْع تكسير الزمان اسم مفرد النائبات جمْع مؤنث سالِم محكّ اسم مفرد أبوك الأسماء الخمسة يتمنى فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ يرْجو فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ أخوك الأسماء الخمسة تشكو فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ يشكيك تَدْعُوه فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ يجيبك فِعْل مضارِع لم يتَّصلْ بآخِرِه شيءٌ س92: ضَعْ في الأماكن الخالية مِن العبارات الآتية اسمًا من الأسماء الخمسة المرفوعة بالواو: أ - إذا دعاك..... فأجبه. ب- لقد كان معي..... بالأمس. ج - ... كان صديقًا لي. د- هذا الكتاب أرْسَله لك....... الجواب: أ - أبوك. ب- أخوك. ج- حَمُوك. د- ذو علم.  س93: ضعْ في المكان الخالي من الجُمل الآتية جمْع تكسير مرفوعًا بضمَّة ظاهرة في بعضها، ومرفوعًا بضمَّة مقدَّرة في بعضها الآخَر. أ - .......أعوانك عند الشدة. ب- حضر..... فأكرمتهم. ج- كان معنا أمس...... كرام. د- ..... تفضح الكذوب. الجواب: أ- إخوانك. ب- أصحابي. ج- فتيان. د- المحن. [1] أساة جمع آسٍ، وهو الطبيب، القاموس المحيط (أ س و) .
[2] سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حُكم سبِّ الدهر كما في كتاب "فتاوى العقيدة" (ص: 59). فأجاب قائلاً: سبُّ الدهر ينقسِم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يقصدَ الخبر المحض دون اللَّوْم، فهذا جائزٌ، مثل أن يقول: تعبْنَا من شدَّة حرِّ هذا اليوم، أو برده، وما أشبه ذلك؛ لأنَّ الأعمال بالنيات، واللفظ صالِح لمجرَّد الخبر*. القسم الثاني: أن يسبَّ الدهر على أنه هو الفاعِل، كأن يقصد بسبِّه الدهر أنَّ الدهر هو الذي يقلِّب الأمور إلى الخير أو الشر، فهذا شِرْك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ مع الله خالقًا، حيث نسب الحوادث إلى غير الله، وكل مَن اعتقد أن مع الله خالقًا فهو كافر، كما أنَّ من اعتقد أنَّ مع الله إلهًا يستحقُّ أن يعبد فإنه كافِر. = _____________________ * وعلى هذا يحمل المثال الذي ذكرَه الشيخ محمد محيي الدين - رحمه الله. ومنه قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الدنيا ملعونة، ملعونٌ ما فيها)) الحديث، فليس هذا الحديث من بابِ السب؛ إنما هو من باب الخبَر، وأنه لا خيرَ فيها إلا عالِم، أو متعلِّم، أو ذكر الله، وما ولاه. ومنه أيضًا قوله - تعالى - عن لوط - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [هود: 77]؛ أي: شديد، وقوله - تعالى - عن قوم عاد: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴾ [القمر: 19]. =القسم الثالث: أن يُسبَّ الدهر، لا لاعتقادِه أنه هو الفاعل، بل يعتقد أنَّ الله هو الفاعل، ولكن يسبه؛ لأنَّه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا مُحرَّم؛ لأنَّه منافٍ للصبر الواجب، وهو مِن السفه في العقل، والضلال في الدين، لأنَّ حقيقة سبه تعود إلى الله - سبحانه - لأنَّ الله - تعالى - هو الذي يُصرِّف الدهر، ويكون فيه ما أراد مِن خير أو شر، فليس الدهر فاعلاً، وليس هذا السب بكُفر؛ لأنه لم يسبَّ الله - تعالى - مباشرة، ولو سبَّ الله مباشرة لكان كافرًا . ا.هـ. وقال ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد" (2/355): فسابُّ الدهر دائرٌ بين أمرين، لا بدَّ له من أحدهما: إما سبه لله، أو الشرك به، فإنَّه إذا اعتقد أنَّ الدهر فاعل مع الله، فهو مشرِك، وإنِ اعتقد أنَّ الله وحده هو الذي فعَل ذلك وهو الذي يسبُّ مَن فعله، فقد سبَّ الله. ا.هـ [3] يقال: أشكى فلانًا؛ يعني: أرْضاه وأزال سببَ شكواه، ويُقال: أشْكاه على ما يشكوه: أعانه، المعجم الوسيط (ش ك و).
|
|
#4
|
|||
|
|||
 أسئلة على نيابة الألف عن الضمة س94: في كم موضِع تكون الألِفُ علامةً على رفْع الكلمة؟ الجواب: تكون الألف علامةً على رفْع الكلمة في موضِع واحد فقط، وهو المثنَّى. س95: ما هو المثنَّى؟ مَثِّل للمثنَّى بمِثالين: أحدهما مُذكَّر، والآخر مُؤنَّث. الجواب: المثنى اصطلاحًا هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزِيادة ألِف ونون في آخِرِه في حالةِ الرَّفْع، وياء ونُون في آخِرِه في حالتي النَّصْب والجر، أغْنَت هذه الزِّيادة عن العاطِف والمعطوف، صالِح للتجريد. ومثال المثنَّى المذكَّر، قوله - تعالى -: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [المائدة: 23]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ [يوسف: 36]. ومثال المثنَّى المؤنَّث: قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: 46]. س 96: رُدَّ كل جمْع من الجموع الآتية إلى مفردِه، ثم ثَنِّ المفردات، ثم ضَعْ كل مثنًّى في كلام مفيد، بحيث يكون مرفوعًا، وها هي ذي[1] الجموع: جِمال، أفيال، سيوف، صهاريج، دُوِيٌّ، نجوم، حدائِق، بساتين، قراطيس، مخابز، أحذية، قُمُص، أطبَّاء، طُرُق، شرفاء، مقاعِد، علماء، جُدران، شبابيك، أبواب، نوافذ، آنِسات، رُكَّع، أمور، بلاد، أقطار، تفاحات. الجمْع / هذان طريقانِ يُوصلانِ إلى الجنةالمفرد/ المثنَّى/ وضْع هذا المثنَّى في كلامٍ مفيد بحيث يكون مرفوعًا جِمال جَمَل جملان هذان جملانِ في بيتنا أفيال فيل فِيلان هذانِ فيلانِ كبيران سيوف سيْف سَيفان هذان سيفانِ حادَّان صَهاريج صِهْريج صِهْريجان[2] هذان صِهْريجان في منـزلنا دُوِي دَواة دَواتان هاتانِ دواتان أَحْضرتُهما لأكتُبَ بهما نجوم نجم نجمان هذان نَجْمان ظهرَا في السماء حدائق حديقة حديقتان هاتانِ حديقتان جميلتانِ بساتين بُسْتان بستانان هذان بستانان كبيرانِ قراطيس قِرطاس قِرطاسان هذان قرطاسانِ أكتُب فيهما مخابز مخبز مخبزان هذان مخبزانِ في شارِعنا أحذية حِذاء حِذاءان هذان حذاءانِ ضَخْمان قُمُص قميص قَميصان هذانِ قَميصان جديدان أطباءُ[3] طبيب طبيبان هذان طبيبان ماهِران طرق طريق طريقان شُرفاء شريف شريفان هذان رجلانِ شريفان مقاعِد مقعد مَقْعَدان هذان مَقْعدان لَكُما علماء عالِم عالِمان هذان عالِمان جليلان جُدران جِدار جِداران هذان جِداران كبيران شبابيك شُبَّاك شُبَّاكان هذان شُبَّاكان يُطِلاَّنِ على الشارع أبواب باب بابان هذان بابانِ مُغْلَقان نوافذ نافذة نافِذتان هاتانِ نافذتانِ تُطِلاَّن على الشارع آنسات آنسة آنستانِ هاتان آنستانِ محتجبتانِ رُكَّع راكِع راكِعان هذان رجلانِ رَاكِعان أمور أَمْر أمْران هذان أمْران جيِّدان بلاد بَلَد بَلدان هاتانِ بَلدانِ مسلِمتان أقطار قُطْر قُطْران هَذان قُطْران مسلِمان تُفَّاحات تُفَّاحة تُفَّاحتان هاتانِ تُفَّاحتان طيِّبتا س97: ضعْ كلَّ واحد من المثنيات الآتية في كلامٍ مفيد: العالِمان، الواليان، الأَخَوان، المجتهدان، الهاديان، الصَّدِيقان، الحديقتان، الفتاتان، الكتابان، الشريفان، القُطْران، الجِداران، الطبيبان، الأمْران، الفارسان، المقعَدان، العذراوان، السَّيْفان، الماجِدان، الخطابان، الأبوان، البلدان، البستانان، الطريقان، راكعان، دولتان، بابان، تفاحتان، نجمان. العالمان: العالمان المسلِمان يَخافانِ ربهما. الجواب:الواليان: جاء الواليانِ العادلان. الأخوان: ذَهَب الأخوانِ إلى المسجد. المجتهدان: المجتهدان في طَلَبِ العِلم الشرعي لهما أجْرٌ كبير. الهاديان: الكتاب والسُّنة هُمَا الهاديانِ إلى طريق الجنة. الصديقان: الْتقَى الصديقان في المسجدِ الحرام. الحديقتان: الحديقتان مملوءتانِ بالأشجار. الفتاتان: جاءتِ الفتاتانِ مِن المدرسة. الكتابان: هَذانِ الكتابان جاءَا بالأمس. الشريفان: جاءَ الشريفانِ إلى مجلس القاضي. القطران: هذانِ القُطْران يدين أهلُهما بالإسلام. الجداران: ثبَت الجِداران بالرغم مِن شِدَّة الزلزال. الطبيبان: اعتنَى الطبيبانِ بالمريض عنايةً فائقة. الأمران: هذان الأمران وصلاَ الآن من الأمير. الفارسان: حضَر الفارسانِ إلى أرضِ المعركة. المقعدان: هذان المقعدانِ لَكُما. العَذْراوان[4]: الفتاتان العَذْراوان تُجيدانِ القراءة. السيفان: برَق السيفانِ في ضوء الشمس. الماجدان: الطالبانِ الماجدان أحقُّ بالاحترام من غيرهما. الخطابان: أتَى الخِطابان بنصر المسلمين وسحْق اليهود[5]. الأبوان: حضَر الأبوانِ إلى المسجد. البلدان: هذانِ البلدان انتصَر فيهما المسلِمون على اليهود. البستانان: البستانان خرجَتْ ثِمارُهما طيِّبة بإذن ربهما. الطريقان: هذانِ الطريقان، طريقَا الكتاب والسُّنَّة، يُوصلان إلى رِضوانِ الله - عزَّ وجلَّ. راكعان: هذان رَجُلان راكعانِ. دولتان: مصْر والجزائر دولتانِ تقعان على ساحلِ البحر الأبيض المتوسط. بابان: المعتزلة والرافِضة بابان للشرِّ. تُفَّاحتان: وقعَتْ تفاحتان على الأرض أثناءَ جَنْي الثمار. نجمان: سقَط نجمانِ البارحة من السَّماء. س98: ضعْ في الأماكن الخالية من العبارات الآتية ألفاظًا مُثنَّاة: (أ) سافر..... إلى مصر ليشاهدا آثارها. (ب) حضر أخي، ومعه..... فأكرمتهم. (جـ) وُلِدَ لخالد... فسمى أحدهما محمدًا، وسمى الآخر عليًّا. (أ) السائحان (ب) صاحباه. الجواب:(جـ) ذَكَران. س 99: أعرِب الجُمل الآتية: (أ) جاء العمران؛ أبو بكر وعمر. (ب) قامت المرأتان. (جـ) احترقت السيارتان. (د) استنار القمران. المثال الأول: جاء العُمران أبو بكر وعمر: جاء: فِعل ماضٍ مبني على الفتح. العمران: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعه الألف نيابةً عن الضمة؛ لأنه ملحَق بالمثنَّى. أبو: بدل من "العمران" مرفوع؛ لأنَّ بدل المرفوع يكون مرفوعًا، وعلامة رفْعه الواو نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف. وبكر: مضاف إليه مجرور، وعلامة جرِّه الكسرة الظاهرة في آخره. وعمر: الواو حرْف عطف، وعمر معطوف على "أبو" مرفوع، وعلامة رفعه الضَّمَّة الظاهرة في آخِرِه، ولم ينوَّن للعلمية والعدل. المثال الثاني: قامتِ المرأتان: قامت: فعل ماضٍ مبنيٌّ على الفتْح، والتاء تاء التأنيث، حرْف مبني على الكسر العارِض لالتقاءِ ساكنين. المرأتان: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى. المثال الثالث: احترقتِ السيَّارتان: احترقت: فعْلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتْح، والتاء تاء التأنيث، حرْف مبني على الكسر العارض لالتِقاء ساكنين. السيَّارتان: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعِه الألف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنه مثنًّى. المثال الرابع: استنار القمران: استنار: فِعْل ماضٍ مبنيٌّ على الفتْح، لا محلَّ له من الإعراب. القمران: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعِه الألف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مُلْحق بالمثنى. وإنَّما كان "القَمَران" و"العمران" ملحقَيْن بالمثنَّى، وليسَا مثنيين؛ لأنَّهما وإن كانَا وردَا على صورة المثنَّى، لكنَّهما فقدَا شرطًا من شروط التثنية، وهو أن يتَّفق الاسمان المراد تثنيتهما في اللفْظ. والقاعدة عندَ النحاة: أنَّ الكلمة التي وردتْ في اللغة على صورةِ المثنى، لكنها فقدَتْ بعض الشروط الواجبِ توافرُها في الكلمة ليصحَّ تثنيتها، أو لم ينطبقْ عليها معنى المثنَّى، فإنَّها تكون مُلْحَقة بالمثنَّى؛ ولذلك ألحق النَّحاة "القَمَران" "والعُمَران" بالمثنَّى. والله أعلم. [1] ذي: اسم إشارة للمفردة المؤنَّثة.
[2] الصِّهْريج – بكسر الصاد: حوض يجتمع فيه الماء، مختار الصحاح (ص ر هـ ج). [3] لا تُصرَف؛ لأنَّها مختومة بألف التأنيث الممدودة الزائدة. [4] العذراوان: تثنية عَذْراء، وعَذْارء - كما هو معلوم – اسمٌ ممدود، والنُّحاة، قد ذَكَروا أنَّ الاسم الممدود عند تثنيته تُقلب همزته واوًا إن كانتْ للتأنيث، وتبقى على حالها إنْ كانت أصلية، ويجوز الوجهان إن كانتْ للإلحاق، أو منقلبة عن أصْل، نحو: صحراوان، وإنشاءان، وعلباءان، أو علباوان، وسماءان أو سماوان؛ انظر "القواعد الأساسية" للهاشمي (ص56). [5] اللهمَّ عجِّل بنصْر المسلمين على اليهود يا حيُّ يا قيوم.
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
أسئلة على نيابة النون عن الضمة س100: في كم موضع تكون النونُ علامةً على رفْع الكَلِمة؟ وبماذا يبدأ الفعل المضارع المسند إلى ألِف الاثنين؟ وعلى أيِّ شيء تدلُّ الحروف المبدوء بها؟ وبماذا يبدأ الفعل المضارع المسند للواو أو الياء؟ مَثِّل بمثالين لكلٍّ من الفعل المضارع المسنَد إلى الألف، وإلى الواو، وإلى الياء، وما هي الأفعال الخَمْسة؟ الجواب: تكون النون علامة على أنَّ الكلمة التي هي آخِرها مرفوعة في موضِع واحِد، وهو الفِعل المضارع إذا اتَّصل به ألفُ الاثنين أو الاثنتين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطَبة المؤنثة. يبدأ الفعل المضارع المسنَد إلى ألِفِ الاثنين بأحدِ حرْفين: 1- الياء: للدَّلالة على الغَيبة. 2- التاء: للدَّلالة على الخِطاب. وأمَّا الفِعل المضارع المسنَد إلى ألف الاثنين، فإنَّه لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء للدَّلالةِ على تأنيثِ الفِعْل، سواء أكان غائبًا، أم كان حاضرًا مخاطبًا. والفِعل المضارع المسنَد لواو الجماعة: إمَّا أن يكون مبدوءًا بالياء للدَّلالةِ على الغَيْبة، وإمَّا أن يكون مبدوءًا بالتاء للدَّلالةِ على الخِطاب، وأمَّا الفعل المضارع المسند لياءِ المخاطَبة المؤنَّثة، فإنه لا يكون إلا مبدوءًا بالتاء فقط، وهي دَالَّة على تأنيث الفعل. فتلخَّص لك أنَّ المسند إلى الألف يكون مبدوءًا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءًا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء. وذاكم هي الأمثلةُ على الفعل المضارع المسنَد إلى الألف، وإلى الواوِ، وإلى الياء: أولاً: الأمثلة على الفعل المضارع المسند إلى الألف: المثال الأول: قوله - تعالى -: ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ﴾ [الأحقاف: 17]. المثال الثاني: قوله - تعالى -: ﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ [يوسف: 41]. ثانيًا: الأمثلة على الفعل المضارع المسنَد إلى الواو: المثال الأول: قوله - تعالى -: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: 9]. المثال الثاني: قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ [الأنبياء: 82]. ثالثًا: الأمثلة على الفِعل المضارع المسنَد إلى الياء: المثال الأول: قوله - تعالى -: ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [هود: 73]. المثال الثاني: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تشتهين تنظرين؟))[1]. وقد عرَّف النحاةُ الأفعالَ الخمسة فقالوا: الأفعال الخَمْسة هي كلُّ فِعل مضارع اتَّصل بآخرِه ألف الاثنين، أو واو الجَمَاعة، أو ياء المخاطَبة. ويُعبَّر عنها أحيانًا بالأوزان، فيقال: الأمثِلة الخمسة، وهي: تفعلان – يفعلان – تفعلون – يفعلون – تفعلين. وهكذا كلُّ فعل مضارع إذا أريد جعْله من الأفعال الخمسة يمكن أن تأتيَ به على وزن من الأوزان السابِقة، نحو: أنتُما تحبَّانِ اللهَ ورسولَه. أنتم تحبُّون اللهَ ورسولَه أنتِ تحبِّين اللهَ ورسولَه. هُما يُحبَّان اللهَ ورسولَه. هُم يُحبُّون اللهَ ورسولَه.  س100: ضَعْ في كلِّ مكان من الأمكِنة الخالية فِعلاً مِن الأفعال الخمسة مناسبًا، ثم بيِّن على أيِّ شيء يدلُّ حرْف المضارَعة الذي بدأته به: أ- الأولاد.... في النهر. ب- الآباء.... على أبنائهم. ج- أنتما أيها الغُلامان.... ببطء. د- هؤلاء الرجال.... في الحقل. هـ- أنتِ يا زينب.... واجبك. و- الفتاتان.... الجندي. ز- أنتم أيُّها الرجال.... أوطانكم. ح- أنت يا سعاد.... بالكُرَة. الجواب: أ- يَسبحون – الغَيْبة. ب- يعطفون – الغَيْبة. ج- تمشيان – الخِطاب. د- يَزرعون – الغَيبة. هـ- تُؤَدِّين – الخِطاب. و- تُحيِّيَان – الغَيبة. ز- تحِبُّون – الخِطاب. ح- تلعبين – الخِطاب.  س101: استعملْ كلَّ فعْل مِن الأفعال الآتية في جُملة مُفيدة: تلعبان، تؤدِّين، تزْرعون، تحصدان، تُحَدِّثانِ، تسيرون، يسبحون، تَخْدمون، تنشئان، ترضَين[2]. الجواب: • تَلعبان: أنتما تَلعبانِ بالكُرة. • تؤدِّين: أنت تؤدِّين عملَكِ بنشاط. • تزرعون: أنتم تزرعون الأرضَ بجِد. • تحصدان: أنتما تَحصُدانِ الزَّرْع بسرعة. • تُحدِّثان: أنتما تُحدِّثان بالواقِع. • تسيرون: أنتم تسيرون في طريقِ الخير. • يَسْبَحون: الصيَّادون يَسْبَحون بمهارةٍ شديدة. • تخدمون: أنتم تخدمون أَبَاكُم بحبٍّ ووفاء. • تُنشئان: أنتما تُنشِئان رُوحًا طيبة بين الناس. • تَرضَين: ألاَ تَرضَين يا أيَّتها الفتاة بما يُرضِي الله ورسولَه؟  س102: ضعْ مع كلِّ كلمة مِن الكلمات الآتية فِعلاً مِن الأفعال الخمسة مناسبًا، واجعلْ مع الجميع كلامًا مفيدًا: الطالبان، الغلمان، المسلمون، الرِّجال الذين يؤدُّون واجبهم، أنت أيتها الفتاة، أنتم يا قومِ، هؤلاء التلاميذ، إذا خالفتِ أوامرَ الله. الجواب: • الطالبان: الطالبان يجتهدانِ في تحصيلِ العِلم الشرعي. • الغلمان: الغلمان يَلْعَبون في فناءِ المدرسة. • المسلمون: المسلمون يَفْدُون الإسلامَ بأرواحهم. • الرِّجال الذين يؤدون واجبهم: الرِّجال الذين يؤدون واجبَهم هم الذين يتَّقون الله - عزَّ وجلَّ. • أنتِ أيتها الفتاة: أنتِ أيتها الفتاة تَطلُبين العلمَ الشرعي. • أنتم يا قومِ: أنتم يا قومِ تُحبُّون الله ورسولَه. • هؤلاء التلاميذ: هؤلاء التلاميذُ يَتعلَّمون العقيدةَ الصحيحة في المساجد. • إذا خالفتِ أوامر الله: إذا خالفتِ أوامرَ الله فسوف تَندمِين وقتَ لا ينفع الندم  س103: بيِّن المرفوع بالضمة، والمرفوع بالألِف، والمرفوع بالواو، والمرفوع بثُبوت النون، مع بيانِ كلِّ واحدٍ منها، من بيْن الكلمات الواردة في العبارات الآتية: • كُتَّاب الملوك عَيْبَتُهم [3] المصونة عندَهم، وآذانهم الواعية، وألسنتهم الشاهدة. • الشجاعة غريزة يَضعُها الله لمَن يشاء مِن عباده. • الشكر شُكران: بإظهار النِّعْمة، وبالتحدُّث باللِّسان، وأولهما أبلغُ مِن ثانيهما. • المتَّقون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخِر. الجواب: الكلمة المرفوعة بالضمة الكلمة المرفوعة بالألف الكلمة المرفوعة بالواو الكلمة المرفوعة بثبوت النون بيان النوع كتَّاب جمْع تكسير عَيبتهم اسم مفرد المصونة اسم مفرد آذانهم جمْع تكسير الواعية اسم مفرد ألسنتهم جمْع تكسير الشاهدة اسم مفرد الشجاعة اسم مفرد غريزة اسم مفرد يضعها فعْل مضارع لم يتصلْ بآخِرِه شيءٌ الله اسم فرد[4] يشاء فعْل مضارع لم يتصلْ بآخِرِه شيءٌ الشُّكر اسم مفرد شكران مثنًّى أولهما اسم مفرد أبلغ اسم مفرد المتَّقون جمْع مذكَّر سالِم يؤمنون الأفعال الخَمْسة  س104: أعرِبِ الجُملَ الآتية: • الرِّجال يقومون. • أنتِ تقومين. • جاءتِ المرأتانِ كلتاهما. الجواب: الجُملة الأولى: الرِّجال يقومون. الرِّجال: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفْعه الضمَّة الظاهِرة؛ لأنَّه جمْع تكسير. يقومون: فعْل مضارع مرفوع؛ لتجرُّده من الناصِب والجازم، وعلامة رفْعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمْسة، والواو ضمير مبنيٌّ على السكون، في محلِّ رفْع فاعل، والجُملة من الفِعل والفاعل في محلِّ رفْع، خبر المبتدأ "الرجال". الجملة الثانية: أنتِ تقومين: أنتِ: "أنْ" ضمير مبنيٌّ على السكون، في محلِّ رفْع مبتدأ، والتاء حرْف خِطاب للمفردة المؤنَّثة. تقومين: فِعْل مضارع مرفوع؛ لتجرُّده من الناصِب والجازم، وعلامة رفْعه ثُبوت النون؛ لأنَّه مِن الأفعال الخمْسة، والياء ضمير مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفْع فاعل، والنون علامة الرَّفْع، والجملة مِن الفعل والفاعل في محلِّ رفْع، خبر المبتدأ "أنتِ". ولا يصحُّ أن تقول في هذين المثالين: يقوموا، تقومي - بحذف النون؛ لأنَّ هذين الفِعلين مرفوعانِ، والفعل المضارع إذا اتَّصلَتْ به ألفُ الاثنين أو الاثنتين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطَبة المؤنَّثة، ولم يُسبَقْ بناصب أو جازم وَجَب فيه إثباتُ النون[5]. الجملة الثالثة: جاءتِ المرأتان كلتاهما. جاءت: جاء: جاء فعلٌ ماضٍ مبني على الفتح، لا محلَّ له من الإعراب، والتاء تاء التأنيث، حرْف مبنيٌّ على الكسر العارض؛ لالتقاءِ ساكنين، لا محلَّ له مِن الإعراب. المرأتان: فاعِل مرفوع، وعلامة رفْعه الألِف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مثنًّى، والنون عوض عن التنوينِ في الاسم المفرد. كلتاهما: كلتا توكيد لـ"المرأتان" وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفْعه الألِف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مُلحَق بالمثنَّى، وكلتا مضاف، والهاء ضمير مبنيٌّ على الضم، في محل جرِّ مضاف إليه، والميم حرْف عماد، والألِف حرْف دالٌّ على التثنية.  س105: بيِّن ما هو الصحيح لُغةً في هذه العبارات؟ ولماذا؟ مع إعرابها: • قام أبوك، أم: أباك؟ • قام أبو زيد، أم: أبا زيد؟ • قام الزيْدَانِ، أم: قام الزيْدَينِ؟ • الرِّجال يقوموا، أم: يقومون؟ • قامتِ المسلماتُ، أم: المسلماتِ؟ • قام رجلانِ اثنان، أم: قام رجلين اثنين، أم: قام رجلين اثنان، أم: قام رجلانِ اثنين؟ الجواب: العبارة الأولى: الصحيح: قام أبوك؛ لأنَّه فاعلٌ مرفوع بالواو. وإعراب هذه العِبارة هكذا: قام: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتْح، لا محلَّ له من الإعراب. أبوك: أبو: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعه الواو نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مِن الأسماء الخمسة، و"أبو" مضاف، والكاف ضمير المخاطَب مبنيٌّ على الفتح، في محلِّ جر، مضاف إليه. العبارة الثانية: الصحيح: قام أبو زيد؛ لأنَّه فاعلٌ مرفوع بالواو. وإعراب هذه العبارة هكذا: قام: كما تقدَّم في العبارة الأولى. أبو: فاعل مرفوع، وعلامةُ رفْعِه الواو نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مِن الأسماء الخمسة، و"أبو" مضاف. وزيد: مُضاف إليه مجرور، وعلامة جرِّه الكَسْرة الظاهرة. ويُلاحَظ في هاتين العبارتين أنَّ كلمة "أبو" أُعرِبت إعرابَ الأسماء الخمسة بالواو رفعًا؛ وذلك لأنَّها أتتْ مفردة، مُكَبَّرة، مضافة إلى غيرِ ياء المتكلِّم، فقد أُضيفتْ في العبارة الأولى إلى ضمير "كاف المخاطَب" وأضيفتْ في العبارة الثانية إلى اسمٍ ظاهر "زيد". العبارة الثالثة: الصحيح: قام الزيدان؛ لأنَّه فاعلٌ مرفوع، وهو مثنًّى، فيرفع بالألِف. وإعراب هذه العبارة هكذا: قام: كما تقدَّم. الزيدان: فاعلٌ مرفوع، وعلامة رفْعه الألِف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مثنًّى، والنون عوض عن التنوين في الاسمِ المفرد. العبارة الرابعة: الصحيح: الرِّجال يقومون؛ لأنَّ "يقومون" مِن الأفعال الخمسة، ولم يدخلْ عليها ناصب، ولا جازم، فتُرفع بثبوت النون. وإعراب هذه العبارة هكذا: الرِّجال: مبتدأ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامة رفْعِه الضمَّة الظاهرة. يقومون: فعْل مضارع مرفوع، لتجرُّده مِن الناصب والجازم، وعلامة رفْعِه ثبوت النون، والواو ضمير مبنيٌّ على السكون، في محلِّ رفْع فاعل، والنون علامةُ الرفع. والجملة مِن الفِعل والفاعل في محلِّ رفْع، خبر المبتدأ "الرِّجال". العبارة الخامِسة: الصحيح: قامتِ المسلماتُ، بالضمَّة؛ لأنَّها فاعلٌ مرفوع، وهي جمْع مؤنَّث سالِم، وجمْع المؤنَّث السالِم يُرفَع بالضمَّة. وإعراب هذه العبارة هكذا: قامتِ: قام: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتْح، لا محلَّ له من الإعراب، والتاء تاءُ التأنيث، حرفٌ مبنيٌّ على الكسْر العارض لالتِقاءِ ساكنين، لا محلَّ له من الإعراب. المسلماتُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفْعِه الضمَّةُ الظاهرة على آخِرِه. العبارة السادسة: الصحيح: قام رجلان اثنان. فـ"رجلان" بالألف. لأنَّه فاعل مرفوع، وهو مثنًّى، والمثنَّى يُرفَع بالألف، و"اثنان" بالألِف أيضًا؛ لأنها توكيدٌ لـ"رجلان" مرفوع، وهي مُلحَقة بالمثنَّى، والملحق بالمثنَّى يُعرَب إعراب المثنَّى، فيرفع بالألِف. ولماذا لم يجعل "اثنان" مثنًّى حقيقيًّا؟ الجواب: لأنه ليس له مفردٌ مِن لفْظه، فلا يُقال في مفرد اثنان: اثن، ولكن مفرده من غيرِ لفظه، وهو: واحد. وإعراب هذه العبارة هكذا: قام: كما تقدَّم. رجلان: فاعلٌ مرفوع، وعلامة رفْعه الألف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مثنًّى، والنون عوض عن التنوين في الاسمِ المفرد. اثنان: توكيد لـ"رجلان" وتوكيد المرفوع مرفوعٌ، وعلامة رفْعِه الألف نيابةً عن الضمَّة؛ لأنَّه مُلحَق بالمثنَّى.  س106: ما تقول في "كلاَّ، وكلتا" هل هما مُلحقانِ بالمثنَّى؟ وما هو شرْط لحوقهما به؟ الجواب: "كلا، وكلتا" ملحقانِ بالمثنَّى، وشرْط لحوقهما به أن يُضافَا إلى ضمير تثنيَّة، فلا يجوز أنْ يُضافَا إلى ضميرِ إفْراد، أو ضمير جمْع، فلا يجوز: كلاه، أو كلاهم، ونحو ذلك. [1] البخاري (950)، ومسلم 2/609 (892)، الحديث رقم (19) من كتاب صلاة العيدين.
[2] إنَّما فُتِح هنا الحرف الذي قبل الياء "الضاد" للدَّلالةِ على الألِف المحذوفة، فأصل هذا الفِعل مكوَّن من الفعل المضارع تَرضَى، وياء المخاطبة، ونون الرفع: "ترضين"، فالْتقَى ساكنان: "الألف والياء"، والقاعدة: أنَّه إذا الْتقَى ساكنان، وكان الحرفُ الأول منهما حرفَ عِلَّة، فإنَّه يُحذَف، وبالتالي يُصبح الفعل "ترضَين" وتبقى الضاد مفتوحةً للدَّلالةِ على الألِف المحذوفة. والله أعلم. [3] عيبة الرجل: موضِع سِرِّه، ج: عيب، وعياب، وعيبات، القاموس المحيط (ع ي ب). [4]ولا يُقال في حقِّ الله تعالى: مفرد؛ ذكَره الشيخ ابن عثيمين في "شرح الألفية" في أوَّل باب الموصول. [5]وهذا إجمالاً، وإلا فقدْ تُحذف نون الرفْع مِن الفعل المضارع، وإنْ كان مرفوعًا، لم يسبقْه ناصب، ولا جازم، وانظر "شرح الآجرومية".
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
س وج على شرح المقدمة الآجرومية (12/44)
أسئلة على علامات النصب، وعلى الفتحة ومواضعها س107: كم للنَّصْب من علامة؟ الجواب: للنصب خمسُ علامات، هي: الفتحة، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون. والذي دلَّ عليها: التتبُّع والاستقراء؛ لأنَّ علماء العربية - رحمهم الله - تتبَّعوا كلام العرب، فوجَدوا أنَّ علاماتِ النصب لا تخرج عن هذه الأشياء الخمسة؛ الفتحةِ، وهي الأصل، والباقي نيابة عنها. • • • • س108: لماذا ثنَّى المؤلِّف بالألف بعدَ الفتحة على الرغم مِن كون العلامات الأربع كلها نائبةً عن الفتحة؟ الجواب: قدَّم - رحمه الله - الألِف على غيرها مِن العلامات الفرعية؛ لأنَّ الفتحة إذا أشبعت تولَّد منها الألف، فإذا قلت: زيدَا، ومددْت صارتْ الفتحة ألفًا. قال الشيخ حسن الكفراوي في شرْحه للآجرومية (ص29): وذكر الألف بعدَ الفتحة، لكونها بِنتَها، تنشأ عنها إذا أُشْبِعت ا. هـ. • • • • س109: في كم موضِع تكون الفتحةُ علامةً على النصب؟ الجواب: تكون الفتحةُ علامةً على أنَّ الكلمة منصوبةٌ في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: الاسم المفرد. والموضع الثاني: جمْع التكسير. والموضع الثالث: الفِعل المضارع الذي سبقَه ناصب، ولم يتصلْ بآخِرِه شيء. وسَبَق أنْ قُلنا: إنَّ المراد بقوله: شيء، خمسة أشياء، هي: ألف الاثنين، وياء المخاطَبة المؤنَّثة، وواو الجماعة، ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، ونون النِّسوة. • • • • س110: مَثِّل للاسم المفرَدِ المنصوب بأربعة أمثِلة: أحدها: للاسم المفرد المذكَّر المنصوب بالفتحة الظاهِرة، وثانيها: للاسم المفرَد المذكَّر المنصوب بفتحة مُقدَّرة، وثالثها: للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة الظاهِرة، ورابعها: للاسم المفرد المؤنَّث المنصوب بالفتحة المُقدَّرة. الجواب: أولاً: مِثال الاسم المذكَّر المنصوب بالفتحة الظاهِرة: قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 177]. الشاهِد من الآية: قوله سبحانه:﴿الكُفْرَ﴾. فهو اسمٌ مفرد مذكَّر منصوبٌ بالفتحة الظاهرة. ثانيًا: مثال الاسم المفرد المذكَّر المنصوب بفتحة مُقدَّرة: قوله - تعالى -: ﴿وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: 87]. الشاهد من الآية: قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿عيسى﴾، فهو اسم مفرد مذكَّر منصوب بفتحةٍ مُقدَّرة، منَع مِن ظهورها التعذُّر. ثالثًا: مثال الاسم المفرَد المؤنَّث المنصوب بالفتحة الظاهِرة: قوله - تعالى -: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: 72]. الشاهِد من الآية: قوله - تعالى -: ﴿الأمانة﴾، فهي اسمٌ مفرَد مؤنَّث منصوب بالفتحة الظاهرة. رابعًا: مثال الاسم المفرد المؤنَّث المنصوب بالفتحة المُقدَّرة: قوله - تعالى -: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 16]. الشاهِد في الآية: قوله - تعالى -: ﴿نَفْسِي﴾، فهي مفرَد مؤنَّث منصوب بالفتحة المقدَّرة، منَع من ظهورها اشتغالُ المحل بحرَكة المناسبة. • • • • س111: مَثِّل لجمع التكسير المنصوبِ بأربعة أمثلِة مختلفة؟ الجواب: المثال الأول: قال - تعالى -: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: 21]. فقوله سبحانه: ﴿رُسُلَنَا﴾ مثال على جمْع التكسير المنصوب بفتحة ظاهِرة، ومفرده مذكَّر "رسول". المثال الثاني: قال - تعالى -: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ [الحج: 2]. فقوله سبحانه: ﴿سُكَارَى﴾ مثال على جمْع التكسير المنصوب بفتحة مقدَّرة، ومفرده مذكَّر "سكران". المثال الثالث: قوله - تعالى -: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [النمل: 60]. فقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿شَجَرَهَا﴾ مثال على جمْع التكسير المنصوب بفتحة ظاهِرة، ومفرده مؤنَّث "شجرة". المثال الرابع: بعثت نِسائي إلى المسجد ليتعلمْنَ. فـ"نسائي" مثال على جمْع التكسير المنصوب بفتحة مُقدَّرة، ومفرده مؤنَّث "امرأة". • • • • س112: متى يُنصَب الفعل المضارع بالفَتْحة؟ الجواب: يُنصب الفعل المضارع بالفتحة بشرطين: الشرط الأول: إذا دخَل عليه ناصبٌ، وهذا الشرط لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن يُنصب الفعل المضارع إلا إذا دخَل عليه ناصب. الشرط الثاني: ألا يتَّصلْ بآخِرِه شيء، ويُريد بالشيء: نوني التوكيد والنِّسوة، وألِف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطَبة المؤنَّثة. فإنِ اتصل الفعلُ المضارع بواحدٍ مِن هذه الخمسة، لم يُنصبْ بالفتحة، وإن سبقَه ناصب. فإنه إن اتَّصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة اتصالاً مباشرًا، بُنِي على الفتح، وإن سبَقَه ناصب. وإنِ اتَّصل بنون النِّسوة، بني على السكون، وإن سبَقَه ناصب. وإنِ اتَّصل بألِف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطَبة المؤنَّثة، وسبَقَه ناصبٌ، فإنه يُنصب بحَذْف النون لا بالفتحة، والله أعلم. • • • • س113: مَثِّل للفعل المضارع المنصوب بمثالين مختلفين؟ الجواب: المثال الأول: قوله - تعالى -: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾ [طه: 91]. فـ ﴿نبرحَ﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿لَنْ﴾، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المثال الثاني: قوله - تعالى -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، فـ﴿يُتِمَّ﴾ فعل مضارع منصوب بـ﴿أَنْ﴾، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. • • • • س114: بماذا يُنصَب الفعل المضارِع الذي اتَّصل به ألف الاثنين؟ الجواب: يُنصب الفعل المضارع الذي اتَّصل به ألِف الاثنين بحذْف النون. • • • • س115: إذا اتَّصل بآخرِ الفعل المضارع المسبوق بناصب نونُ توكيد، فما حُكمه؟ الجواب: يُبنَى على الفتْح، في محل نصب. • • • • س116: مَثِّل للفعل المضارِع الذي اتَّصل بآخره نون النِّسوة، وسبقَه ناصب، مع بيان حُكمه؟ الجواب: مثال الفِعل المضارع الذي اتَّصل بآخره نون النسوة وسبَقَه ناصب: قوله - تعالى -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: 228]. فالفعل "يكتُمْنَ" فعل مضارع اتَّصل بآخره نونُ النِّسوة، وسبقه ناصب "أن". وحُكمه: أن يُبنى على السكون في محلِّ نصب. • • • • س117: أيقول القائل: أكرمتُ الطلبةَ، أم الطلبةِ، أم الطلبةُ؟ الجواب: الصحيح: الطلبةَ. ولماذا نصبْناها بالفَتْحة؟ الجواب: لأنَّها جمْعُ تكسير. وما الذي أعلمنا أنها جمْعُ تكسير؟ الجواب: تَغيُّر حالِ مفردها. وما هو مفردها؟ الجواب: الطالِب. • • • • س118: إذا قلنا: أكرمتُ الطالب، فكيف تُحرِّك الباء من كلمة "الطالب" هل تقول: الطالبُ، أم الطالبَ؟ ولماذا؟ الجواب: الطالبَ، بالنصب؛ لأنَّه مفعول به، وهو اسمٌ مفرَد، والاسم المفرَد يُنصب بالفتحة. • • • • س119: استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة، بحيث تكون منصوبةً؟ الحقل، الزَّهْرة، الطلاَّب، الأُكْرَة[1]، الحديقة، النهر، الكتاب، البستان، القلم، الفرس، الغلمان، العَذارى [2]، العصا، الهُدى، يشرب، يرضَى، يَرْتَجي، تسافر. • الحقل: زَرَع أبي الحقلَ قمحًا. • الزهرة: قَطَف الولدُ الزهرةَ مِن البستانِ. • الطلاب: ما أحسنَ طلاَّبَ العلمِ الشرعي! • الأُكْرَة: تركنا الأُكْرَة في الملْعَب، وذهبْنا نُصلِّي. الحديقة: رأيتُ الحديقةَ مثمرةً. • النهر: قال - تعالى -: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا﴾ [الكهف: 33]. • الكتاب: قال - تعالى -: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13]. • البستان: رأيتُ البستانَ في الصباح مليئًا بالأشجار. • القلم: إنَّ القلمَ أداةٌ لنشْر الحق والعدْل بين الناس. • الفَرَس: رأيتُ الفَرسَ في الإسطبل. • الغلمان: رأيتُ الغلمان يلعبون بالكُرة. • العَذَارى: ما أحسنَ العذارى إذا اتقين الله! • العصا: رأيتُ العصا في يدِ الساحرِ تهتزُّ. • الهُدى: قال - تعالى -: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ [البقرة: 120]. • يشرب: لا أَوَدُّ أن يشرب محمَّد الدواء ثانية. • يرضَى: قال - تعالى -: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: 120]. • يَرتجي: إنَّ محمدًا يَرْتجِي الخيرَ من ربِّه. • تُسافر: لا يحلُّ لك أن تُسافِرَ إلى بلاد الكفَّار إلا بشروط [3]. س120: ضعْ في كل مكان مِن الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسمًا مناسبًا منصوبًا بالفتحة الظاهرة، واضبطه بالشكل؟ (أ) إنَّ.... يعطفون على أبنائهم. (ب) أطِع.... لأنَّه يهذبك ويثقفك. (ج) احترمْ... لأنها ربَّتْك. (د) ذاكر.... قبل أن تحضرها. (هـ) أدِّ..... فإنَّك بهذا تخدم وطنك. (و) كُن... فإنَّ الجبن لا يؤخِّر الأجل. (ز) الْزم... فإنَّ الهذر[4] عيب. (ح) احفظْ... عن التكلم في الناس. (ط) إنَّ الرجل... هو الذي يؤدِّي واجبه. (ي) مَن أطاع.... أوردَه المهالك. (ك) اعمل... ولو في غيرِ أهله. (ل) أحسن... يرضَ عنك الله. (أ) الآباءَ. (ب) معلِّمَك. (ج) أمَّك. (د) دُروسَك. (هـ) واجبَك. (و) شجاعًا. (ز) الأدبَ. (ح) لسانَك. (ط) المسلمَ. (ي) الشيطانَ. (ك) الخيرَ. (ل) عملَك. [1] الأُكْرَةُ - بالضم - لُغَيَّةٌ في الكُرَة، والحُفرة يجتمع فيها الماء، فيغرف صافيًا. القاموس المحيط (أ ك ر).
[2] العَذارى: جمْع عذراء، وهي البِكْر، المعجم الوسيط (ع ذ ر). [3] اعلم - رحمك الله - أنه إذا كان الإنسان مِن أهل الإسلام، ومِن بلاد المسلمين، فإنه لا يجوز له أن يُسافر إلى بلدِ الكفر؛ لما في ذلك من الخَطَر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفَّار، ونحن مأمورون بأن نَغيظَ الكفار بكلِّ ما نستطيع، كما قال - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: 120]. فالكافر أيًّا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو مِن الملحِدين، وسواء تسمَّى بالإسلام، أم لم يتسمَّ بالإسلام، الكافِر عدوٌّ لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًا، مهما تلبَّس بما يتلبس به فإنَّه عدو، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلدِ الكفر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون عنده عِلم يدفَع به الشبهات؛ لأنَّ الكفار يُوردون على المسلمين شُبهًا في دِينهم، وفي رسولهم، وفي كتابهم، وفي أخلاقهم، وفي كل شيء يُوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكًّا متذبذبًا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شكَّ في الأمور التي يجب فيها اليقين، فإنَّه لم يقمْ بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخِر والقَدَر خيرِه وشرِّه يجب أن يكون يقينًا، فإن شكَّ الإنسان في شيءٍ من ذلك، فهو كافِر. فالكفار يُدخِلون على المسلمين الشك، حتى إنَّ بعض زعمائهم صرَّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دِينه إلى دين النصارى، ولكن يَكفي أن تُشكِّكوه في دينه؛ لأنكم إذا شككتموه في دِينه سلبتموه الدين، وهذا كافٍ. أنتم أخْرجوه من هذه الحظيرة التي فيها العِزَّة والغلبة والكرامة، ويَكفي، أما أن تحاولوا أن تُدخِلوه في دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة، فهذا لا يمكن؛ لأنَّ النصارى ضالون كما جاءَ في الحديث عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اليهود مغضوبٌ عليهم، والنصارَى ضُلاَّل))، وإن كان دِين المسيح دينَ حقٍّ، لكنه دينُ الحق في وقتِه قبلَ أن يُنسخ برسالة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم. الشرط الثاني: أن يكون عندَه دِين يحميه مِن الشهوات؛ لأنَّ الإنسان الذي ليس عنده دِين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يجد زهرةَ الدنيا هناك؛ مِن خمر وزِنا ولواط، وغير ذلك. الشرط الثالث: أن يكونَ محتاجًا إلى مثل ذلك، مثل أن يكون مريضًا، يحتاج إلى السَّفَر إلى بلادِ الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجًا إلى عِلم لا يوجد في بلادِ الإسلام تخصّص فيه، فيذهب إلى هناك، أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة، يذهب ويتَّجر ويرجع، المهم أن يكون هناك حاجة؛ ولهذا يرى كثيرٌ من العلماء أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجلِ السياحة فقط - يرَوْن أنهم آثمون، وأنَّ كل جنيه يصرفونه لهذا السفر فإنَّه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيُحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يَجدون مكانًا يتفسَّحون فيه، أو يتنـزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم؛ لأنَّ هؤلاء يُضيِّعون أوقاتهم، ويُتلفون أموالَهم، ويفسدون أخلاقَهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائِلُهم، ومن العجبِ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلادِ الكفر التي لا يُسمع فيها صوتُ مؤذن ولا ذِكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواقُ اليهود ونواقيس النصارى، ثم يَبقُون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شرٌّ كثير - نسأل الله العافية والسلامة. وبإمكانِ الإنسان المسلم أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلُها على شعائرِ الإسلام، ويَقضي زمن إجازته فيها. والسَّفر إلى بلاد الكفر للدعوةِ يجوز إذا كان له أثرٌ وتأثير هناك؛ لأنَّه سفرٌ لمصلحة، وبلاد الكفر كثير مِن عوامهم قد عُمِّى عليهم الإسلام، لا يَدرون عن الإسلام شيئًا، بل قد ضُلِّلوا، وقيل لهم: إنَّ الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع، ولا سيَّما إذا سمع الغربُ هذه الحوادث التي جرَت على يد أناس يقولون: إنهم مسلمون، سيقولون: أينَ الإسلام؟ هذه وحشية! فينفرون من الإسلام بسببِ المسلمين وأفعالهم، نسأل الله أن يَهديَنا أجمعين، وانظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين - رحمه الله - (ص 237، 238). [4]الهذر: سقط الكلام. المعجم الوسيط (هـ ذ ر)
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
س وج على شرح المقدمة الآجرومية (13/44)
أسئلة على نيابة الألف عن الفتحة س 121: في كم موضِع تنوب الألِفُ عن الفتحة؟ الجواب: تنوب الألِفُ عن الفتحة في موضِعٍ واحدٍ فقط، وهو الأسماء الخمسة. س122: مَثِّل للأسماء الخمسة في حالِ النصب بأربعة أمثلة؟ الجواب: المثال الأوَّل: قال - تعالى -: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم: 14]،فـ"ذا" بمعنى صاحِب من الأسماء الخمسة، وهو منصوبٌ - لأنَّه خبر "كان" - بالألف، نيابةً عن الفتحة. المثال الثاني: قال - تعالى -: ﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ [يوسف: 61]. فـ"أباه" اسم من الأسماء الخمسة، وهو منصوب - لأنه مفعول به - بالألف، نيابةً عن الفتحة. المثال الثالث: قال - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ [النمل: 45] فـ"أخاهم" اسمٌ مِن الأسماء الخمْسة، وهو منصوبٌ - لأنه مفعول به - بالألف، نيابةً عن الفتحة. المثال الرابع: قال تعالى: ﴿ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴾ [الرعد: 14] فـ"فاه" اسمٌ من الأسماء الخمسة، وهو منصوبٌ - لأنه مفعول به - بالألِف، نيابةً عن الفتحة. س123: كيف تقول في هذه العِبارة: رأيتُ فمَك، أم: رأيت فوك، أم: رأيت فاك؟ ثم أعرب ما صوَّبت. الجواب: تقول: رأيت فمَك، وبناء على لغة أخرى: رأيت فاك. فـ"فم" فيها لغتان: اللُّغة الأولى بإثبات الميم، وفيها تُعرَب بالحركات؛ بالضمَّة والفتحة والكَسْرة، واللُّغة الثانية بحذفِ الميم، وفيها تُعرَب بالحروف؛ بالواو رفعًا، وبالألِف نصبًا، بالياء جرًّا. وأمَّا إعراب ما صوَّبنا، فهكذا: رأيتُ: رأى: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكون؛ لاتِّصاله بتاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم، في محلِّ رفْع فاعل. فمك: "فم": مفعول به منصوب، علامة نصْبه الفتحة الظاهرة، و "فم" مضاف، والكاف: ضمير مبنيٌّ على الفتح في محلِّ جر، مضاف إليه. فاك: "فا" مفعول به منصوب، وعلامة نصْبه الألِف نيابةً عن الفتحة، و"فا" مضاف، والكاف: ضميرٌ مبنيٌّ على الفتْح في محلِّ جر، مضاف إليه.
|
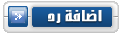 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الآجرومية., المقدمة, د, ص, شرح, على, و |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|